ما خلا بعض الأمثلة النادرة، فقد درج المشتغلون بالفلسفة المعاصرة على تصنيف الفيلسوف الفرنسيّ جاك دريدا كأحد فلاسفة ما بعد الحداثة إن لم يكن عرَّابهم. والسؤال الذي سنحاول أن نجيب عليه في مقالنا هذا هو : هل كان دريدا حقّاً فيلسوفاً ما بعد حداثيّ؟ وهذا السؤال سيقودنا منطقيّاً إلى سؤالٍ آخر : هل كان فعلاً ضدّ مشروع الحداثة؟ لا شكّ أنّ البعض يرى أنّ الإجابة على مثل هذه الأسئلة واضحة وبديهيّة فيؤكِّدون : نعم، دريدا أحد ممثّلي ما بعد الحداثة فقد كرَّس جهده لتفكيك الحداثة الغربية. أما بالنسبة لنا فإنّ الإجابة على هذه التساؤلات ليست بتلك البساطة، بل نحتاج التوقّف عند نصوصه محاولين استنتاج موقفه بهذا الشأن.
في حين أنه يمكن لنا أن نقول بوضوح مثلاً إنّ الفيلسوف الفرنسي جان فرانسوا ليوتار كان ما بعد حداثيٍّ بامتياز إذ عبَّر عن موقفه بشكلٍ واضحٍ وصريح(1)، فإنّنا لا نجد في مجموع أعمال دريدا ما يساعدنا على استنباط موقفه بشكلٍ جليٍّ من الحداثة. تُظهر لنا مؤلّفات دريدا بما لا يقبل الشكّ أنّ مفهوم "الحداثة" لم يُمثَّل بالنسبة له سؤالاً نظرياً فلسفياً قائماً بذاته يستوجب التفكيك. من الواضح أن التفكيكيّة الدريديّة لم تحفل يوماً بهذا المفهوم كما فعلت مثلاً مع مفاهيم فلسفية أخرى من قبيل : ميتافيزيقا الحضور، أو العقل المتمركز على الذات le logocentrisme، أو العطيّة le don، أو العفو، أو الضيافة، أو الصداقة، أو العدالة، أو الديمقراطيّة، أو الإرهاب الخ الخ.
مهما يكن من أمر، فإن من الجليِّ أن دريدا قد نأى بنفسه عن ذلك الجدل الذي ثار في ثمانينات القرن الماضي حول الحداثة وما بعد الحداثة. حتى أنّ هذين "المصطلحين" لا يردان في نصوصه إلا نادراً وحين يظهران، فإننا لا نلمح فيهما تلك الشحنة الإيديولوجيَّة المُعتادة : مع أو ضدّ. إذا كان ذلك كذلك، فمن أين جاءت إذن تلك الفكرة عن دريدا ما بعد حداثويّ؟ يبدو أنّها صدرت عن تلك الإشاعة المُبسَّطة وغير المدروسة التي تُطابق ما بين التفكيكية الدريديّة والهدم العبثيّ وتتحدّث عنها بوصفها معولَ تقويضٍ نيتشويٍّا جديدَا لا يُخلِّف وراءه سوى الدَّمار والهباء.
من المعروف أيضاً أنّ دريدا قام بتفكيك نصوصٍ مفتاحية للخطاب الفلسفي للحداثة مثل أعمال جان جاك روسو وخاصة نصِّه محاولة في أصل اللغات، أو الدين في حدود العقل ومشروع السلام الدائم لكانط، أو مبادئ فلسفة الحقّ لهيغل الخ، ولكنّ كلّ هذا لا يسمح لنا أن نستنتج ببساطة أن دريدا كان ما بعد حداثيّ. لا ننسَ إذن أنّ دريدا قام بتفكيك نصوصٍ فلسفيّة سابقة على ما يُعرف بالحداثة الأوروبيّة. هكذا فإنّه قام بتفكيك محاورة فيدر لأفلاطون ونظريّة المجاز في كتابي "في الشِّعر" و"الخطابة" لأرسطو. بهذه الطريقة قام أيضاً بقراءة كتاب الاعترافات للقديس أوغسطين.
إنّ ما نريد التأكيد عليه هنا، هو أنّ دريدا لم يقم فقط بتفكيك بعض المفاهيم والأفكار الثّاوية في بعض النصوص الفلسفيّة والأدبيّة التي ترجع لمرحلة الحداثة وتنتسب إليها، وإنما قام أيضاً بتفكيك بعض النصوص الماقبل حداثيّة، بل ونصوصاً ما بعد حداثيّة كذلك. لنتذكر إذن أنّ ماكينة التفكيك الدريديّة قد طالت نص تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكيّ لفوكو، وكذلك مسألة الهيغليّة عند جورج باتاي، ونص ما وراء مبدأ اللذة لفرويد، بل إنّ دريدا قد ذهب حدّ تفكيك بعض نصوص أُستاذه هيدغر.
بمعنى آخر، لم يكن همّ دريدا الأساسيّ يتمثّل في تفكيك ميتافيزيقا الحداثة، وإنّما في تفكيك تاريخ الميتافيزيقا الغربيّة منذ لحظة ميلادها مع سقراط وأفلاطون والكشف عن آثارها في جملة نصوص ماقبل حداثيّة، وحداثيّة، بل وما بعد حداثيّة تزعم أنها تجاوزت الميتافيزيقا. هكذا فإنّ التفكيك الدريديّ الذي كشف عن ميتافيزيقا الحضور في مركزيّة الصوت، ومركزيّة العقل، ومركزيّة القضيب، والمركزيّة الأوروبيّة الخ لم يقتصر في ذلك على تفكيك نصوص مرحلة الحداثة الغربيّة وإنما امتدّ شغله على طول مساحة خريطة الفلسفة الغربيّة منذ الإغريق وحتى أيامنا هذه.
إذ تستوي لدى دريدا نصوص أفلاطون أو كانط أو فوكو، فإنّ ذلك يجعل موقفه من الحداثة مخاتلاً وغير قابلٍ للضبط، وهذا بالضبط على ما يبدو ما قسم آراء الباحثين حول هذا الموضوع؛ فمن جهة هناك أولئك (وهم كثر) الذين يصنّفون دريدا (بتسرُّع بعض الشيء) ضمن قائمة المعادين لمشروع الحداثة، كما فعل هابرماس مثلاً بتأكيده : "يمتدّ هذا الاتجاه في فرنسا من جورج باتاي إلى دريدا مروراً بفوكو. عند جميع ممثّلي هذا الاتجاه تهمس بالتأكيد روح نيتشه المعاد اكتشافه في سنوات السبعينات"(2). ومن جهةٍ أُخرى، هناك أولئك الذين ينفون عن دريدا "تهمة" ما بعد الحداثة. نذكر بهذا الصدد الموقف الجريء للفيلسوف الانجليزي سيمون كريتشلي الذي يقول: "أودّ أن أُبدِّد سوء الفهم فيما يتعلق بموضوع أعمال دريدا. ليس دريدا ولم يكن أبداً ما بعد حداثيّ، شخصاً يستخدم التهكُّم لغرضٍ خاص. ولا هو كذلك بالمتصوِّف الهيدغريّ الجديد أو الفوضويّ. ليست أعماله دفاعاً عن العدميّة، ولا هي أيضاً رفضاً للتنوير أو محاولةً لتجاوزه، أو مهما يكن من هذا القبيل(3)."
في سوقنا لهذه الأمثلة المتناقضة هل نكون بذلك قد أجبنا على السؤال أم أننا عقّدنا الإجابة أكثر ممّا هي مُعقّدة؟ أياً يكن، فنحن هنا على وعيٍّ تامّ أنّنا وبمحاولة تصنيف دريدا وحشره بين الحداثويين أو ما بعدهم، نقوم بخيانة دريدا مرتين. المرّة الأولى لأنّ دريدا ما كان ليقبل أبداً أن يتمّ تقيد حركته وحجزه في أية فئة كائنةً ما كانت وكأنّ لسان حاله ما قاله أُنسي الحاج يوماً : "من صنّفك قتلك". والمرّة الثانيّة لأنّ التفكيك الدريديّ يرفض أن يقوم على ذلك التقابل الميتافيزيقي بين الثنائيات من قبيل المثالية والماديّة، الحداثة والمعاصَرة، العامّ والخاصّ، الخير والشرّ، الصحيح والخاطئ، الجسد والروح. بمعنى أنّ دريدا يرفض هذا التعارض ذا الصبغة الميافيزيقيّة ما بين الحداثة وما بعد الحداثة أو ما كان قد أسماه فوكو في نصه "ما التنوير؟" بذلك الابتزاز السياسي والثقافي الممارس من قبل البعض (في إشارة لا تُخطئ لهابرماس) بأن تكون مع الحداثة أو ضدّها(4). برفض دريدا ذلك التقابل الميتافيزيقي المزدوج يتجنّب الفخّ الذي سقط فيه كلّ من هابرماس وليوتار بتمترس كلٍ منهما في الطرف المقابل للآخر.
على الرغم من وعينا بهذه المفارقة وبهذه الخيانة المزدوجة، فإننا سنحاول أن نقترب مع ذلك من موقف دريدا من هذا الموضوع محاولين ضبط ما لا يمكن ضبطه. مع غياب النصوص الدريديّة الواضحة بهذا الصدد فإننا نجد في تلك المقابلة التي أُجراها دريدا مع أستاذ الفلسفة في جامعة بوسطن ريتشارد كيرني جواباً بشكلٍ ما على أسئلتنا. في ذلك اللقاء يجيب دريدا على سؤال "هل هناك علاقة بين التفكيكية والحداثة؟" بالقول : "لم أشعر أبداً بالسرور من مصطلح "الحداثة". لا شك أنني أشعر بأنّ ما يحصل في العالَم اليوم هو شيء فريد ووحيد، ولكن، ما أن نلصق عليه بطاقة "الحداثة"، حتى نصفه بنسقٍ تاريخيٍّ ما للتطور والتقدّم (وهي فكرة مُشتقة من عقلانية عصر الأنوار) وهو ما يسعى لأن يعمينا عن رؤية حقيقة أن ما يواجهنا اليوم هو أيضاً شيءٌ قديم ومحجوب في التاريخ. أنا أؤمن بأن ما "يحدث" في عالمنا المعاصر وما يفاجئنا بوصفه جديداً جزئياً، لديه في الحقيقة رابطة جوهريّة مع شيءٍ قديمٍ جداً (محجوب منذ القِدَم). وعليه فإنّ الجديد ليس تماماً هو ما يظهر للمرة الأولى، وإنما هو ذلك البُعد "القديم جدّاً" الذي يتجلّى في "الحديث جداً"؛ والذي كان يُمنح دلالة على نحوٍ مُتكرّر عبر تقاليدنا التاريخيّة في اليونان وفي روما، عند أفلاطون وعند ديكارت وكانط الخ. ليس المهمّ مدى جدّة المعنىً الحديث الذي يمكن أن يظهر، فهو لم يكن أبداً حديثاً بشكلٍ حصريّ وإنما وفي نفس الوقت ظاهرةً من ظواهر التكرار. (5)"
في هذا المقطع الدريديّ يتنكّر القديم بثوب "الحديث" الأكثر معاصرةً تماماً كما كان عليه الأمر عند بودلير وبنيامين. لكنّ الطريف في موقف دريدا هذا هو تداخل وتشابك الأزمنة إذ لا يعود الزمن عنده زمناً خطياً من ماضٍ يحيل إلى حاضرٍ يحيل بدوره إلى مستقبل وإنما تداخلٌ في الأزمة فالأشباح تتفلت من أزمنتها في الماضي والمستقبل على حدٍ سواء لتسكن الحاضر. (كان يمكن في هذا الإطار لفكرة الفارق la différance الدريدية أن تقدّم لنا إضاءةً لفكرة الحركة والزمن عند دريدا إلا أننا سنؤجّل هذا المشروع).
يمكن أيضاً للعبارة التي استهلّ بها دريدا إجابته بالقول : " لم أشعر أبداً بالسرور من مصطلح "الحداثة"" أن تُعطينا فكرةً عن مزاجه من فكرة "الحداثة" التي ينتقد فيها فكرتيّ التقدّم والتطور، ولكنها لا تكفي لحسم موقف دريدا من الموضوع.
رغم كل ما تقدّم، إلا أن بوسعنا القول : إذا كانت الحداثة مشروعاً، أو مرحلةً تاريخيّةً، أو ذاتيةً، أو عقلانيّةً، أو تبنّياً للعقل بوصفه معياراً متعالياً، أو مجموعة معايير كونيّة، أو قطيعةً نهائيةً مع الماضي، أو إيماناً بالتقدُّم الدائم، أو تأليهاً للإنسان، أو نظاماً للسُلطة، أو سيطرةً متزايدة للإنسان على الطبيعة…الخ، فإنّ دريدا إذن ضدّ مشروع الحداثة. ولكن إذا كانت الحداثة، مواصلةً لقيم التنوير ومراجعةً دائمةً لها بنفس الوقت، أو علاقةً ما بين الزمن والحركة، أو إشكاليةً بين الماضي والحاضر والمستقبل، أو إمكانيّةً سياسية لتغيير قواعد لعبة الحياة الاجتماعيّة، أو إمكانيّة جديدةً تسمح بالتحرُّر في مقابل التقليد، أو محاولةً لتغيير طريقتنا في التفكير، أو نضالاً ضدّ الأحكام الجاهزة والقبليّة، والأفكار المقبولة والجاهزة… الخ، فإنّ دريدا إذن هو أحد فلاسفة الحداثة بجدارة.
في حين أنه إذا كان ما بعد الحداثة مجرّد مرحلةٍ تاريخيّة لاحقة على مرحلة الحداثة، أو رفضاً كاملاً ومجانياً للعقل والعقلانيّة، أو قطيعةً تامة، بل وعداءً للحداثة والتنوير، فليس لدريدا أية علاقة تُذكر بما بعد الحداثة. ولكن في حال كانت هذه الأخيرة في المقابل كُفراً بالسرديات الكُبرى، أو رفضاً لأولويّة العقليّ والذكريّ على ما هو غير عقلانيّ وأنثويّ، أو تجاوزاً للذات، أو تفكيكاً للأنا وللذاتيّة، أو أفضليةً وأولويّةً للانتشار على الوحدة، وللهامشي والثانوي على الأساسيّ، وللمخبوء والمحجوب على المكشوف والمُعطى، وللغياب على الحضور، وللاوعي على الوعي، فإنّ دريدا بهذه الحالة هو فيلسوفٌ ما بعد حداثيّ بكل معنى الكلمة.
مرّة أُخرى يزداد تشابك الخيوط بين يدينا كلّما حاولنا تسريحها وحلّها من بعضها البعض. بين دريدا الحداثيّ ودريدا ما بعد الحداثيّ، يمكن لنا أن نلاحظ أن دريدا الأوّل، أي دريدا حتى بداية ثمانينات القرن الماضي، كان أقرب إلى روح ما بعد الحداثة، في حين أنّ دريدا الثاني، أي دريدا ابتداءً من سنوات الثمانينات، كان أكثر ابتعاداً عن مزاج ما بعد الحداثة وأكثر تعاطفاً مع روح الحداثة والتنوير الأوروبيين.
الهوامش:
1- Jean-François Lyotard, La Condition Postmoderne, Minuit, Paris, 1979
2- Habermas, « La modernité : un projet inachevé », trad. franç. Gérard Raulet, in Critique, n° 413, « vingt ans de pensée allemande », oct. 1981, p. 966.
3- Simon Critchley, « Déconstruction et communication. Quelques remarques sur Derrida et Habermas », pp. 53-70, in Derrida : la déconstruction, Coordonné par Charles Ramond, puf, 2005, p. 53.
4- Foucault, Qu’est-ce que l’Aufklärung ?, P. 70.
5- « Dialogue with Jacques Derrida », in Richard Kearney, ed., Dialogues with Contemporary Continental Thinkers (Manchester University Press, 1984), pp. 112-113.
5- « Dialogue with Jacques Derrida », in Richard Kearney, ed., Dialogues with Contemporary Continental Thinkers (Manchester University Press, 1984), pp. 112-113.
هل كان دريدا فيلسوفاً ما بعد حداثيّ؟
بقلم: خلدون النبواني
بقلم: خلدون النبواني


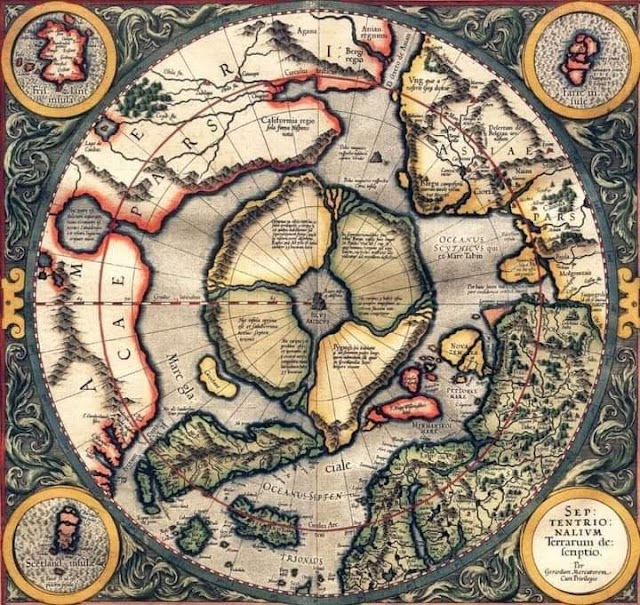



0 تعليقات
أكتب لتعليق